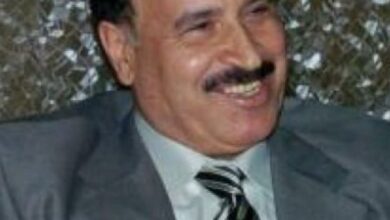” المؤرخون الشناقطة وكتابة التاريخ”.. قراءة في كتاب ” منّي بونعامة” / خالد عمر بن ققه
في هذا الكتاب يعمل بونعامة على توضيح مسألة أساسية، هي: علاقة المؤلفين الشناقطة ـ المؤرخون تحديدا ـ بكتابة التاريخ، من خلال الفكر وقضايا الوعي والمنهج، وهو بذلك بتناول صناعة الفكر الشنقيطي في شقه الإبداعي في سياق زمن محدد، يُظهر لنا الفعل الثقافي في موريتانيا المعاصرة.
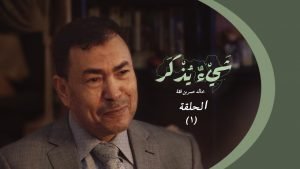
يأتي ذكر موريتانيا ـ الأرض والسكان ـ مُحمَّلاً دائما بنوع من المساءلة التاريخية لأهلها، وللعرب أيضا، لجهة الكشف عن جذور الظهور، والعطاء الثقافي، والتراكم المعرفي، والجمع التراثي، كما يطرح إشكاليَّة تعميق البحث على مستوى” المفاهيم” بهدف إدراك التسجيل التاريخي للأحداث والوقائع، وللفعل البشري بما تحمله حركة الإقامة والظعن، أو في صيرورة الحل والترحال، حيث التاريخ الشفاهي الناتج عن بداوة مكرسة للوجود من جهة، وحاملة للقيم من جهة ثانية، على النحو الذي ذكره” الأمير عبد القادر الجزائري” في قصيدته” يا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر“.
من ناحية أخرى، فإن الحديث عن موريتانيا في وقتنا الحاضر من منطلق الدور الذي تقوم به نُخبُها على مستوى الإسهام الثقافي والحضاري يقودنا بالضرورة إلى استحضار التاريخ بهدف الفهم والتركيز، ولن يتأتَّى لنا ذلك إلا بقراءة المنتج الكتابي للموريتانيَّين حول تاريخهم وعلمائهم وبلادهم، وفي ذلك تكمن أهميَّة قراءة كتاب” المؤرخون الشناقطة وكتابة التاريخ.. دراسة في قضايا الوعي والمنهج” للمؤرخ والباحث الدكتور” منّي بونعامة“
من البداية يُحيلنا مني بونعامة إلى اختيار مقصود وهادف، يتناغم مع عنوان كتابه، وحين نتجاوب معه، ونتفاعل مع درسته، تتلبَّسُنا حالة من الجاذبية نحو أرض شنقيط، ويظهر لنا أهلها في تاريخهم الشفاهي جزءاً من ذاكرة محيطهم، بل والعالم كله، حيث المحافظة ـ بغض النظر عن طرق النقل هنا ـ عن التراث الإنساني، حتى لو كان خارج بيئتهم المحلية ومحيطهم الجغرافي.
 هنا تتبدّى لنا شنقيط عامرةً وزاخرةً بموروثها الشفاهي، وفي التجسيد نراها بالبصيرة مقبلةً من مكان بعيد، وعائدة ومعها أرواح عهود غابرة بينها وبين أهلها المعاصرين أمد بعيد، حتى إذا ما حان وقت الكتابة، وجدوا ما يًرْوون ويُسجلون سواء بمشاركة تراكمية للتاريخ الإسلامي والعربي والأفريقي والمغاربي في البدايات، أو في مرحلة لاحقة لجهة الحديث عن التاريخ الخاص.
هنا تتبدّى لنا شنقيط عامرةً وزاخرةً بموروثها الشفاهي، وفي التجسيد نراها بالبصيرة مقبلةً من مكان بعيد، وعائدة ومعها أرواح عهود غابرة بينها وبين أهلها المعاصرين أمد بعيد، حتى إذا ما حان وقت الكتابة، وجدوا ما يًرْوون ويُسجلون سواء بمشاركة تراكمية للتاريخ الإسلامي والعربي والأفريقي والمغاربي في البدايات، أو في مرحلة لاحقة لجهة الحديث عن التاريخ الخاص.
من ناحية أخرى، فإن بونعامة يقربنا من صوت المكان في رحلة الزمن، ويبدو ـ من أول سطر في الكتاب منتصراً لشنقيط، ليس فقط كونها اسما له دلالة تعمِّق بالوجود والفعل عبر الزمن، وإنما أيضا لأنه يجمع بين صفات السكان وطبيعة المكان، أي في طرح مماثل أو هو أقرب إلى تعريف الحضارة لدى المفكر “مالك بن نبي”، وفي ذلك تجلّ مبكر للهدف من الدراسة.
“كوبلاني”.. وموريتانيا
ومثل كثير من المثقفين الموريتانيين يميل بونعامة ميلا عظيما لاسم شنقيط، أي التأكيد على الاسم من بعده ظهورها محليّاً مغاربِيّاً، ثم الاعتماد والتحيز له مشرقيّاً، فيُبْعدنا بذلك عن الجدل التاريخي لجهة القول: أن” مور” اسم أطلقه الأوروبيون على سكان المغرب العربي والأندلس والأمازيغ، وأن” مورو” اسم أطلقه الفينيقيون على قبائل بدوية أمازيغية تقطن في الصحراء“.
وتبعا لذلك فإن اسم” موريتانيا” يرجع إلى العصر القرطاجي والروماني، وقد أطلق هذا الاسم على منطقة شمال إفريقيا كلها، وعندما برز المشروع الاستعماري الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر بُعث هذا الاسم من جديد حيث اختاره قائد الحملة الفرنسية ” كزافييه كابولاني Coppolani Xavier ” على شنقيط، وبذلك أعاد إحياء اسم موريتانيا.
في هذا الكتاب يعمل بونعامة على توضيح مسألة أساسية، هي: علاقة المؤلفين الشناقطة ـ المؤرخون تحديدا ـ بكتابة التاريخ، من خلال الفكر وقضايا الوعي والمنهج، وهو بذلك بتناول صناعة الفكر الشنقيطي في شقه الإبداعي في سياق زمن محدد، يُظهر لنا الفعل الثقافي في موريتانيا المعاصرة.
في هذا السياق، يقدم لنا ـ بناء على دراسة جادة وواعية وموثقة ـ حكما شبه قطعي يخص الرعيل الأول من المؤلفين الشناقطة لجهة كتابتهم للتاريخ من حيث الاعتراف بوجودهم، لكن دون نيلها الحظ الأوفر من الاهتمام، وقد أرجع ذلك” لأسباب منها ما هو منهجي أو موضوعي، ومنها أسباب أخرى تتعلق بالواقع، الذي نشأ المؤرخ الموريتاني في كنفه من أهوال ومخاوف، في بيئة كانت مرتعا خصبا للصراعات والحروب..”
لاشك أن الحالة التي نشأ فيها المؤرخ الموريتاني تأتي ـ رغم خصوصيتها ــ في سياق حالة مغاربيَّة، لم تول اهتماما للمسألة الثقافة والمعرفية ومنها التاريخ في سياقها المحلي والجواري، بقدر اهتمامها بالبعدين العربي والإسلامي، وهي في الجارة الجزائر أكثر وضوحاً، حيث نجد على سبيل المثال:” حركة عبد الحميد بن باديس التي ركزت على الجانب الثقافي من النهضة الوطنية، لم تعتن في مدارسها بتاريخ الجزائر الثقافي بقدر ما اعتنت بتاريخ العرب والإسلام عموما..”، وذاك ما ظهر أيضا في كتابات المؤرخين الشناقطة على النحو الذي ذكره بونعامة في كتابه هذا.
فترة القرنين.. والتعرَّب الرّسمي
يرى بونعامة ان فكرة التاريخ ظلت غائبة حيناً من الدهر نظراً لانعدام الدوافع والجرأة الكافية لكتابة التاريخ، إلى أن أذنت الخطوب التوالي بتغير النظرة وتبلور الفكرة، عندها انكب القوم على التأليف، وعليه قسّم كتابه إلى فصلين، استعرض الأول نشأة الكتابات التاريخية وسياقها، وأبرز نصوصها وموضوعاتها وخصائصها، وتناول الفصل الثاني المؤرخين ونصوصهم مع تقديم تعريف شامل يفيد في فهم مسيرة كل واحد منهم ونتاجه، ومدى علاقته بممكنات عصره.
حمل الفصل الأول عنوان:” المدونة التاريخية الشنقيطية وسياق إنتاجها.. فترة القرنين 12 ـ 14هـ | 18 ــ 20م)، وفيه ركَّز الكاتب عن الأوضاع الثقافية والفكرية في بلاد شنقيط، ورآها في سياقها الزمنى ملتقى قرنين، حيث تجلَّى” التّعرّب الرسمي”، و”اعتماد الذاكرة“.
وتندرج القضايا بعد ذلك في تتابع معرفي ومنهجي، ومصحوبة بإشكاليات انتهت إلى إجابات مثلت أرحاما لتكوين الوعي عبر تساؤلات، حتى إذا خرجت إلى فضاء الوجود المعرفي أرِتْنا ما كنَّا نبْغي من فعل ثقافي للمؤرخين الشناقطة، وقد تضمَّنتْها عناوين معبرة وكاشفة، منها: الرواية الشفاهية وإشكالية التدوين، وظهور التأليف والمحلي، والمجالات الفكرية.
كما تناول الفصل الأول أيضا نشأة الكتابة التاريخية وتطورها، ومن خلالها كشف المؤلف عن عوائق الكتابة التاريخية، وتبلور الفكرة التاريخية، وبواكير الإنتاج التاريخي وتطوره، وأنواع الكتابة التاريخية، وخصائصها.
وحمل القسم الثالث من الفصل الأول عنوان:” الكتابة التاريخية في بلاد شنقيط خلال القرن العشرين”، وقد تناول فيه جملة من القضايا حملت العناوين الآتية: الملامح العامة، وظهور نصوص جديدة، واهتمام الفرنسيين بتاريخ البلاد، وجهود الدولة الموريتانية.
وفي الفصل الثاني، الذي حمل عنوان” المؤرخون ونصوصهم” أورد الكاتب عدداً من المؤرخين، وأعطاهم أوصافاً، واسبق نصوصهم بسير ذاتيَّة كاشفة ودالَّة عنهم، مراعياً في ذلك زمانهم، ومكانتهم، وأهمية ما كتبوه، منهم:” محمد اليدالي(مؤرخ السير والمناقب)، الطالب محمد البرتلي( المؤرخ التراجمي)، جدو بن الطالب الصغير البرتلي( المؤرخ المحقق)، سيدي محمد الخليفة الكنتي( مؤرخ المناقب)، الطالب أحمد بن اطوير الجنة( المؤرخ الملتزم)، صالح بن عبد الوهاب( مؤرخ الأنساب)، المختار بن حامد( المؤرخ الموسوعي)“.
” فتح الشكور”.. و” حياة موريتانيا“
لقد انتهى بونعامة في كتابه إلى نتيجة مهمة تعني المؤرخين والباحثين” تتعلق بنشأة الكتابة التاريخية في موريتانيا الأمس، لجهة ارتباطها بمسألة الهوية والانتماء والتعريف بالذات سواء كان ذلك ردّاً على قلق داخلي أو صدّاً لتوهم وتشويه خارجي”، وقد تجلّى فيها الدفاع عن الانتماء العربي.
بجانب ذلك هناك جملة من الاستنتاجات والخلاصات توصل إليها الكاتب من خلال دراسته، نذكرها هنا مختصرة على النحو الآتي:
أوّلاً ـ ارتباط الكتابة التاريخية في موريتانيا الأمس ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الخبر عند المؤرخين المسلمين القدماء.
ثانياً ــ مرور الكتابة التاريخية في موريتانيا خلال القرنين (12 ـ 14هـ | 18 ـ20م) بثلاث مراحل، اتّسمت كل منها بميزات فارقة، حيث كانت الأولى محتشمة وخجولة، وقد تميزت الكتابة التاريخية بندرة الإنتاج وشحّ المعلومات، ومع ذلك فقد عرفت ظهور أول معجم تراجمي موسوعي(فتح الشكور)، وتغطي هذه المرحلة من الناحية الزمنية القرن الثاني عشر الهجري| الثامن عشر الميلادي.
وتعدُّ المرحلة الثانية أزهي مرحل الكتابة التاريخية، لأنها تميزت بغزارة الإنتاج التاريخي، ووضوح المادة المدونة، وهي المرحلة التي دُبّجت فيها أبرز النصوص التاريخية الشنقيطية (كتب الحوليات، الأنساب، التراجم.. إلخ)، كما ظهر فيها جيل من المؤرخين الموسوعيِّين، وتغطي من الناحية التاريخية القرن الثالث عشر الهجري| التاسع عشر الميلادي.
واتَّسمت المرحلة الثالثة بتنوع المادة التاريخية وشموليتها، بحيث لم تعد محصورة في المواضيع التقليدية، وتمثل هذه المرحلة أوج التدوين التاريخي من حيث استيعاب المضمون العام، وعمق الوعي التاريخي، ولكنها أقل انتاجا بكثير مقارنة بالمرحلة السابقة(الثانية)، كما تراجعت خلالها إلى حدّ كبير الكتابات الأنسابية والتراجمية، وتمثل موسوعة” حياة موريتانيا” أهم عمل تاريخي فيها، وتغطي هذه المرحلة القرن الرابع عشر الهجري| العشرين الميلادي.
ثالثاً ـ تركيز الكتابة التاريخية الموريتانية في البداية على النمط الحولي والمناقبي والأنسابي والتراجمي، في ظل بعض المواضيع الأخرى خلوّاً من التدوين، كالتاريخ السياسي مثلا.
رابعاً ــ ظهور أهمية النصوص المدونة، رغم ما اعترى بعضها من هفوات وهنات، وقيمتها في التأسيس لكتابة التاريخ بعد التنقيح والتمحيص والمقارنة.
خامساً ـ اسهام نمط الكتابة التاريخية في تمايز” مدارس لكتابة التاريخ”، من ذلك اعتماد مؤرخو المناطق الشرقية والوسط من البلاد التدوين الحولي من خلال سرد الأحداث والوقائع، بينما سلك مؤرخو الجنوب والجنوب الغربي طريقة النظم بحساب الجمل لتدوين الأحداث وضبط الوقائع.
سادساً ــ اعتبار الموسوعة التاريخية” حياة موريتانيا” أول عمل تاريخي ينشد الشمول والاستقصاء/ رغم ما اعتورها من نقص وتشويه وتحريف وتزييف في بعض أجزائها، لكنها تبقى مع ذلك العمل التاريخي الموسوعي الوحيد، الذي فاق كل النماذج السابقة له.
العرب.. والزّاد الموريتاني
الاستنتاجات السابقة تنير لنا دروب المعرفة الخاصَّة بالكاتبة لدى المؤرخين الشناقطة، وتسلك بنا سبل تكريس وعي عربي قد يمدُّ أهله جسوراً من المركز إلى الأطراف، حيث المواجهة الدائمة والصراع لأجل تثبيت الانتماء، وهو ما كشف عنه الدكتور مني بونعامة تأسيساَ وتعريفاً وتحليلاً من خلال هذه الدراسة، فأجْلِسَنا عن قرب من المؤرخين الموريتانيين، وأسكننا فضاءهم المعرفي.
وخُلاصة القول: لقد حقّق الدكتور مني بونعامة ما أشار إليه في مقدمة كتابة حين قال:” سعيْنا في هذا العمل إلى تعريف القارئ العربي بسِيّر أولئك المؤرخين الأعلام، والذي يكاد يجهل أين تقع بلاد شنقيط (موريتانيا حاليا)، من باب أحرى أن يطلع على ثقافتها وأعلامها، باستثناء بعض النخب المثقفة، وقليل ما هم“.
لذلك كلّه، حقَّ له أن يحصل كتابه على جائزة، “جائزة شنقيط في مجال الدراسة الإسلامية والآداب”ـ فرع الآداب والفنون ــ للعام 2021م، وقبلها وبعدها نيل ثقة الباحثين والقراء، وهو أهل لذلك لأنه جعل من تاريخ موريتانيا زاد معرفيّاٍ لنا جميعاً، ودفعنا ـ عن بعد وفي الغياب ـ لنصبح جُلساء مع مؤّرخيها وكتاباتهم.